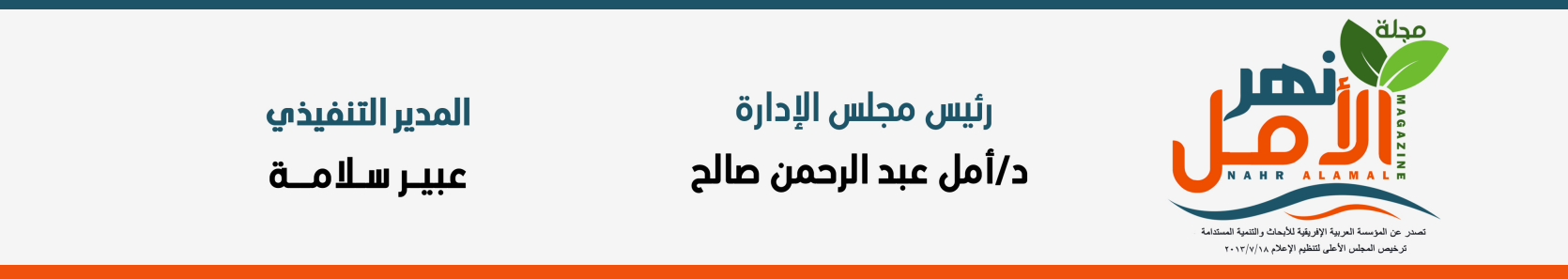كتبت د. هناء سعد الطنطاوي عقاقير المصرية القديمة ما بين العلم والخرافة
إن إبداعات الحضارة المصرية في كافة مجالات الحياة تتطلب دون شك أجسادًا سليمة معافاة إلى جانب عقول متقدمة، فالمجتمع الذي يتسم بسلامة أفراده عقليًا وجسديًا سوف يتسم بإنجازات على نفس المستوى، فالمجتمعات المتحضرة تقاس بمعايير كثيرة من بينها السلامة البدنية، الأمر الذي يتطلب طبًا متقدمًا، فالطب يولد لتأمين حياة الإنسان من أخطار الأمراض التي تصيبه، والتي تتطلب علاجًا حتى يشفى منها. ولا شك أن المصري القديم أدرك هذا بدليل ما حدثتنا عنه البرديات الطبية التي نستنتج منها مدي احترام المصري القديم للفرد.
فيمكن أن نلخص مستوى الطب في مصر القديمة في المقولة الشهيرة (العقل السليم في الجسم السليم)، فلاشك أن الحضارة المصرية التى بنت الهرم وصولًا بعمل التمائم والجعارين الصغيرة جدًا فى الحجم (كما نقول من الإبرة للصاروخ ) لا يمكن إلا أن تكون نتاج لأناس ذوي عقول عبقرية، وبالتالي أجساد قوية سليمة معافاة.
فالمصري القديم قدر قيمة الحياة وحاول الحفاظ على الجسد حيًا بالعلاج وميتًا بالتحنيط.
ودراسة الكثير من البرديات الطبية (إيبرس، إدوين سميث الجراحية، وكاهون وغيرهم)، والتماثيل، والبقايا الآدمية أثمرت عن ثروة للعلماء المهتمين بالأمراض في مصر القديمة، وطرق تشخيصها ثم علاجها بالعقاقير والوصفات العلاجية التي ظهرت قيمتها، وأثبت العلم الحديث فاعلية الكثير منها.
وقد استخلص المصري القديم عقاقيره من كل ما وقعت عليه عينيه في الطبيعة من (نباتات، وحيوانات، ومعادن)، فمن النباتات العرعر، والريحان (الآس)، والسنط والحنظل والبلح، وحب العنب، والبيرة العذبة والنبيذ، والكركم الجبلي، والبابونج، والكرات والثوم، والحلبة، والكمون، والكرفس، والتين، والبقدونس وغيرهم، وهذا يعني دراسة الطبيب المصري القديم للنباتات، ومعرفة استخدام كلًا منهم في العلاج، بل وأنه أثبت أن جميع النباتات طبية، ولكن يوجد نباتات لم تستخدم طبيًا. بل أن المصري القديم درس النباتات وعرف أن منها ما هو نافع ومنها ما هو سام، وكيفية الإستفادة من النباتات السامة هذه وأنه عرف طريقة ما لإبطال مفعول هذا السم بها ربما هي إدخاله لكثير من المواد في الوصفة الواحدة.
فعرف المصري القديم تأثير الغذاء في الشفاء أو بمعني أدق الفيتامينات (لم يحدد المصري القديم اسمًا للفيتامينات كما نفهمها اليوم، ولكنه أدرك فوائدها في علاج الأمراض)، هو ما يعرف اليوم بعلم التغذية. فيقول أبو بكر الرازي “جالينوس العرب” (إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة)، وهذا ما فعله المصري القديم. فعلى الأقل إن لم تنفع فهي لم تضر لأنها وصفات من مواد عضوية، تخلو من السموم (مواد كيماوية) وبالتالي ليس لها آثار جانبية . فتعريف الدواء في علم الصيدلة الحديث هو السم الذي يحتوى على بعض المنافع.
فمن خلال دراسة العقاقير في مصر القديمة لوحظ استخدام وصفات تحتوي على أجزاء نباتات وحيوانات ومعادن، ذات روائح كريهة، في عصرنا الحالي هي مثيرة للغثيان، فنسب البعض ذلك أنه راجع إلى أن المصريون القدماء كانوا يفضلون بعض المواد كريهة الرائحة وبها مرارة قوية، لكون ذلك له علاقة بالسحر حيث كان الاعتقاد السائد بأنه كلما ازدادت درجة الغثيان من روائح المواد الكريهة، كان ذلك دليلًا على فاعلية تلك المادة في طرد المرض (الروح الشريرة) من الجسم. ولكن تعتقد الباحثة أن ذلك ليس له علاقة بأي سحر، وإنما هو قمة العقل والواقعية من الطبيب والمريض، فبالنسبة للمريض فتكمن الإجابة على تعاطيه لمثل تلك الوصفة المقززة للنفس البشرية هي غريزة الشفاء التي ولد بها الإنسان، فكل إنسان لا يتردد في أداء أي شئ في استعادة العافية، وإنقاذ حياته.
أما بالنسبة للطبيب المصري القديم فهو لم يدرس السحر وإن كان هناك سحر فهو سحر التحكم في العقل والنفس، فالمصري القديم عرف أن المرض والشفاء في العقل. لذا استخدم الإيحاء في العلاج والذي أطلق عليه اسم (التعاويذ السحرية). حاليًا ممكن أن نطلق عليها (أقراص الوهم)، فقد آمن المصري القديم أن العقاقير لابد منها، ولكنها ذات مفعول أحيانًا، أما الإيمان فهو ضروري دائمًا لإنجاح العلاج، وإتمام الشفاء. ولعل هذا ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحًا (الدواء ذو الأثر الوهمي). وهذا يعني تمكن الطبيب المصري القديم من دراسة علم النفس البشرية، وهذا غير مستبعد فمن درس الهندسة والطب والفلك وغيرها من العلوم بتلك البراعة، لابد أن يكون دارس لعلم النفس البشري لأن هؤلاء البشر هم الذين قاموا على أكتافهم تلك الحضارة.
كأن المصري القديم أراد أن يجمع بين مداواة الجسم بالعلاج والعقاقير، ومداواة النفس بالإيمان. فالرقى والدواء كل منهما يفيد في مصلحة الآخر. إضافة أن ممارسة السحر إلى جانب التطبيب ما هو إلا لونًا لون من ألوان الإيحاء بالشفاء، لأن أي تغيير في حالة المريض العقلية والنفسية تؤثر بدورها على حيوية الجسد في مقاومة المرض، وبالتالي في شفائه. وهذا ما يحدث في يومنا هذا عند أخذ الدواء نعلم أن الدواء به مادة فعالة لمقاومة المرض، لكننا لا نأخذه بسبب المادة الفعالة التي ربما لا نعرف اسمها، وإنما نأخذه أخذًا بالأسباب، وأن الله هو الشافي البارئ، وكما يقال (الله يشفي، والطبيب يأخذ الشكر).
وهذا هي طريقة العلاج قديمًا وحديثًا لأن النفس البشرية واحدة مهما اختلف الزمان أو المكان.